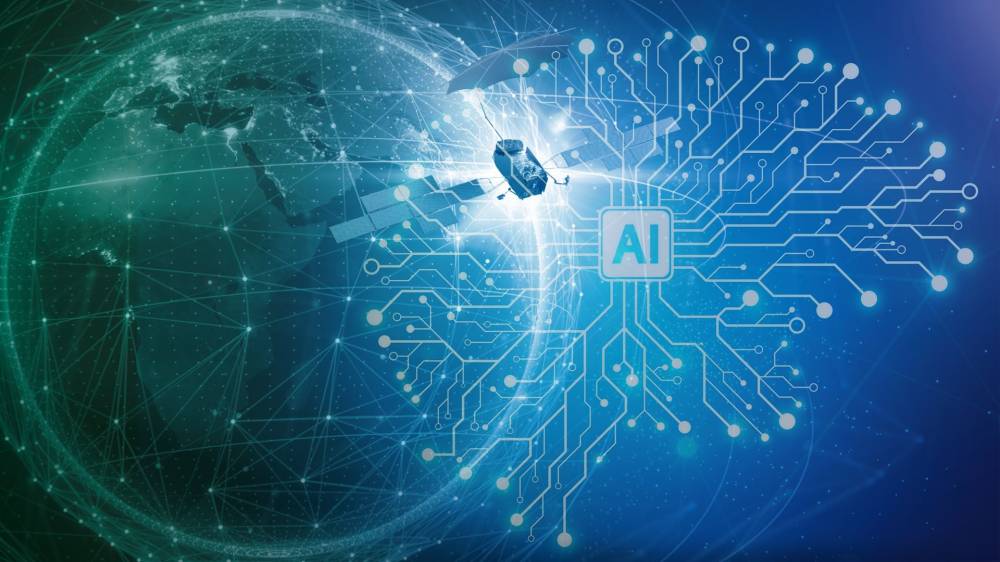أحمد مصطفى
على الرغم من حالة الفوضى والاضطراب السياسي التي شهدتها بريطانيا في الأيام الأخيرة وآثارها السلبية الواضحة، فإنها عكست حقيقة أن الديمقراطية في بريطانيا تختلف عن كل الديمقراطيات الغربية الأخرى، وخاصة تلك التي يتباهى بها ما يسمى العالم الحر في الولايات المتحدة.
بغض النظر عن تفاصيل ما جرى ويجري، إلا أن درساً في غاية الأهمية يمكن استخلاصه من ذلك الوضع.
بريطانيا من بين عدد قليل من دول العالم يعد على أصابع اليد الواحدة ليس بها دستور مكتوب، لكن القياس القانوني يضمن لها نظاماً متفرداً في إدارة شؤون البلاد، ومع وجود الملكية فإن رأس الدولة (الملكة إليزابيث الثانية حالياً) لا يتدخل في أي من شؤونها، فكلها متروكة للبرلمان والحكومة التي يختارها.
شهدت الديمقراطية البريطانية اختبارات عديدة على مر التاريخ الحديث والمعاصر، لكن الاختبار الأخير على مدى أقل من ثلاث سنوات تولى فيها بوريس جونسون رئاسة الحكومة، ومعه فريقه المؤيد له من مجموعة تكاد تكون «اختطفت» حزب المحافظين، يعد من أشدّ وأصعب تلك الاختبارات. ومهما كانت الآثار المترتبة على تلك التجربة، فإن النظام من المرونة والاتزان بما يكفل إصلاحه لنفسه بنفسه، وذلك على الرغم من التراجع الذي يعانيه، مثل بقية التراجعات في الأنظمة الأخرى كلها حول العالم.
استسهل كثيرون في الأيام الأخيرة تشبيه بوريس جونسون بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وتمادى المعلقون والكتاب، خاصة من أسعدته استقالة جونسون من رئاسة الوزراء، في المقارنة بين التوجه «الشعبوي» لجونسون وفريقه، والتوجّه ذاته الذي اعتمده ترامب وربما كان سبباً في خسارته الانتخابات الرئاسية في 2020. لكن للأسف، أغلب تلك الكتابات والتعليقات سقطت في الفخ نفسه الذي تنتقده، وهو «الشعبوية» التحليلية والفكرية.
ببساطة شديدة، ليس بوريس جونسون مثل دونالد ترامب. صحيح أن هناك ما هو مشترك مثل عدم احترام القواعد والقوانين والمغالاة في «العزة بالإثم»، لكن جونسون نتاج مجتمع ومؤسسات تختلف تماماً عن أسواق نيويورك وأعمالها التي أفرزت ترامب؛ فوالد جونسون كان يعمل في الاتحاد الأوروبي وليس بعيداً عن «المؤسسة» بمعناها البريطاني، وبالتالي فمهما كان جموح بوريس وشططه، إلا أنه في خلفية تركيبته «ابن المؤسسة»، بينما ترامب ابن لسمسار عقارات أجاد الالتفاف على القواعد والأصول حتى حوكم وأدين ذات مرة، وزاد دونالد على تركة أبيه تلك الفجاجة في تجاوز الأعراف.
حتى قول البعض إن الاثنين يشتركان في تجربة العمل في «الإعلام» قبل دخول معترك السياسة لا يصلح للمقارنة، فبوريس جونسون بدأ مشواره الصحفي بشكل مهني وحقيقي، من مراسل إلى محرر حتى وصل إلى رئيس تحرير أهم مجلة سياسية محافظة هي «سبيكتاتور»، ثم حين عمل في التلفزيون أنتج برامج وثائقية عالية القيمة تعكس مهارة صحفية وثقافة واطلاعاً، لكن دونالد ترامب لا علاقة له بالصحافة؛ فعلى الرغم من الشهرة الواسعة لبرنامجه التلفزيوني قبل ترشحه للرئاسة، فقد كان في النهاية «استعراضاً» يقدّمه «رجل بزنس» دون أي قيمة مضافة. الخلاصة أن جونسون قرأ كتباً بعدد شعر رأسه (القليل نسبياً)، بينما أهم ما يمكن أن يكون ترامب قد قرأه، ربما، هو صحيفة صفراء.
قد يسخر الأمريكيون، ومعهم بعض «العالم الجديد» مثل أستراليا وكندا وغيرهما، من بريطانيا وأوروبا باعتبارها «القارة العجوز»، لكن تلك العجوز هي جدتهم جميعاً التي لا يمكن إنكار حكمتها التي راكمتها عبر العقود والقرون، وذلك ما يجعل الديمقراطية البريطانية (نظاماً ومؤسسة) متميزة، بل حتى متفردة عن نظيراتها الأوروبية.
لكل تلك الأسباب، قام اليمين البريطاني ممثلاً في حزب المحافظين الحاكم بإجبار زعيمه ورئيس حكومته على الاستقالة من منصبه، وهو ما لم يستطع اليمين الأمريكي ممثلاً في الحزب الجمهوري أن يفعله مع زعيمه، الرئيس السابق. في النهاية سيترك بوريس جونسون مكتبه في مقر الحكومة لأن حزبه لم يعد يريده زعيماً، على الرغم من أنه استنفد أكثر من «تسعة أرواح» (أكثر من القطط) مناوراً بليّ عنق النظام، وقافزاً على القواعد والأصول، لكنه فعل كل ذلك بذكاء يستند إلى خبرة ومهارة. أما دونالد ترامب فلم يترك الحكم لأن حزبه أراد ذلك، بل ما زال حزبه يخشاه ويرى فيه سبيل إنقاذه انتخابياً، وإنما «صورة المؤسسة» في الولايات المتحدة (المنسوخة من بريطانيا) هي التي أخرجته من البيت الأبيض، بغض النظر عن التفاصيل.